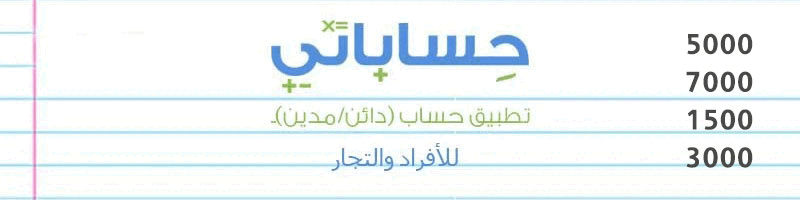"الشقيقتان" .. مجموعة قصصية تثري السرد العربي بالتشويق والفلسفة
يعدّ الكاتب الإماراتي علي العبدان واحدا من المبدعين المخضرمين الذين برعوا في مجالات عملية وثقافية متنوعة توزعت بين الفنون المرئية، وتاريخ الموسيقى، والنقد الفني، وعلم النفس، والشعر… فهو من الكتّاب الذين ترتبك –أمام سعة منجزاتهم- معاييرُ التصنيف… لدرجة قد يحتار فيها المرء أين يضع هؤلاء الموسوعيين الذين تتفرق أعمالهم بين حقول عديدة؟ فيما قد يتساءل البعض الآخر عما إذا بقي –في زمننا هذا- مثقفون بهذا النفس الأرسطي كيما يزاوجوا –علميا وعمليا- بين هذه المجالات المتفاوتة؟ بيد أن حيرة السؤالين سرعان ما تتداعى أمام المنجزات البحثية، والإبداعية، والبصرية، التي أنتجها الكاتب الإماراتي علي العبدان.
ولذلك، سنقف –اليوم- عند مجموعته القصصية: “الشقيقتان” التي رُصَّ خطابها السردي بعمق إبداعي يراوح بين تعقب التفاصيل الطريفة، واستحضار المرجعيات الفلسفية المؤثرة… غير أن ما ينبغي أن يُهتم به –في سياق مقاربة هذه التجربة المتفردة- لا ينحصر في كيفيات انسراب هذه المرجعيات الغنية إلى عضد القصة، ولا بمدى تحمّل ضيق مساحتها سعةَ هذه المعارف الثرية؛ لأن ذلك سرّ مدفون في خلَد النص وكينونة المبدع، بل إن أبرز سؤالين سيواجهان القارئ الفضولي هما: ما الآليات والطرائق التي أسعفت السارد في الانكباب على هذه التفاصيل والأحداث التي لا يُتلفت إليها؟ وكيف أمكن له الحفاظ على نواظم التشويق والعواطف قائمة ومثارة بنحو متتابع طوال قصص المجموعة؟ جاذبية الشكل صدرت مجموعة: “الشقيقتان” -في طبعتها الأولى- سنة 2023 عن منشورات “اتحاد كتاب وأدباء الإمارات”.
وقد ضمت بين ثناياها ثلاث عشرة قصة قصيرة، فضلا عن عشر قصص قصيرة جدا، مما يؤكد مراعاتها للمعايير الإجناسية الدقيقة التي تفصل بين هذين الجنسين الأدبين المتداخلين.
ووقوفا عند العتبات الخارجية، جرى توسيم المجموعة بما مفاده: “الشقيقتان”؛ وهو عنوان له رمزية متميزة، خاصة وأنه يضم عددا مثنى، مما يرجح وجود ثنائيات متنوعة، لاسيما وأن صورة الغلاف تأثثت بشابتين متشابهتين تقابلان بعضهما بمحيا محايد خال من الأحاسيس والتعابير… ولعل فكرة التقابل هي المدخل الأولي إلى تعمق الدلالات الرمزية للعنوان.
ولذا، فالشقيقتان -هنا- قد تكونان فكرتين، مبدأين، فلسفتين، قضيتين، رؤيتين… نرجح أن المبدع سيترجمهما إلى قصص مُعبّرة، وأحداث مؤثّرة، وقيم منبّهة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} واستقصاءً لطبيعة العناوين القصصية التي راوحت بين الجاذبية والإثارة من قبيل: سكان المسوَّدة، الزخارف الإلهية، فحيح، اختلاف في القبر، عصفور من زجاج، سرّ المنمنمة… يلاحظ أن القاص قد استند –في الغالب- إلى وُسوم دالة، لكنها -في الآن نفسه- لا تسلّم محتوياتها بسهولة؛ لأنها تترك مساحة الإبهام والغموض شاخصة بين القارئ والنص، بل إنها تدعوه إلى التخمين في فحوى هذه القصص، انطلاقا مما تثيره في عناوينها، ومما تتصل به من مرجعيات تخص الذاكرة، والفن، والفلسفة، والتراث، والميتافيزيقا… ويبدو أن توظيفه لها كحوافز موضوعية، وجواذب شكلية، كان رغبة في الإيقاع بالقارئ في دهاليز الحكمة المغمورة التي تسكن التفاصيل القصصية.
وتماهيا مع ما سبق، مهّد السارد لعدد من قصصه بأشكال بصرية: “لوحات وصور فتوغرافية”، مع استهلال بعضها بمقتطفات من القرآن الكريم، أو من الآداب العالمية؛ إذ نقل عن غوستاف فلوبير ما مفاده: أن “سلة المهملات هي أفضل أصدقاء الكاتب” (ص.
11).
فيما جرى تسريد قصة “السباحة في عيني بحر يتوحّش” بناء على التفاعل مع منتج إبداعي آخر؛ إذ استوحى السارد عنوانها من إحدى قصص “الأديب الإماراتي عبد الحميد أحمد” (ص.
117).
سردية العاطفة والتشويق وعلى منوال جاذبية الشكل، مضت مجموعة: “الشقيتان” في ابتناء أغلب قصصها وفق ما تقتضيه تقنية إثارة العاطفة والتشويق؛ ومعنى ذلك أن رهان السارد على هاتين التقنيتين كان نابعا من رغبته في تجويد أدوار السرد عامة، والقصة خاصة؛ لأن تحدي إثارة العاطفة والتشويق يمثل أولى الأدبيات التي تضمن نجاح وجودة أي عمل سردي، قصة كان، أم رواية، أم سيرة، أم فليما إلخ.
ولهذا، تقودنا سبل أجرأة المبدع لهاتين التقنيتين إلى ثلاثة اختيارات شكلية وجوهرية اشتغل عليها بطرائق خاصة، أولها: اعتماد عناوين دالة ومثيرة للرغبة في التلقي والاكتشاف كما سبق الإشارة إلى ذلك.
ثانيها: توظيف حبكات وشخصيات هدفها الكبير اقتناص واقتفاء اللا مفكر فيه من خلال تتبع التفاصيل العابرة التي لا يمكن –في زمننا المتسارع- أن تحظى بقسط من التفكير والاهتمام الإنسانيين؛ فعلى سبيل الذكر لا الحصر، اعتنت حبكة قصة “سكان المسودة” بالتغيرات التي تأتي على وسائل الإنسان في مواجهة الحياة، مهتمةً بفعل الكتابة الذي تعرض لهزات الرقمنة… متوسلةً في التعبير عن ذلك شخوص المسودة: “التوقيع، الخربشة…” الذين هالهم حجم التحولات التي لحقت فعل الكتابة منذ 1981 إلى 2021، مثلما أرعبهم الإعدام الرقمي للكلمات؛ وهو الإعدام الذي قضى على المسودة بمفهومها المادي، وعلى سكانها أو بالأحرى ذاكرتها من الأحاسيس والأحداث والمواقف والتأملات.
وثالثها: إعمال العصف الذهني مع استثمار معطى عاطفي لمضاعفة منافذ الإثارة والتشويق على غرار ما هو متعين في قصة “فحيح” التي لا يمكن لمن طالع بدايتها أن يرتاح أو يغمض له جفن إلا بعد بلوغ الاطمئنان المتوتر في نهايتها، يقول السارد في مستهل القصة عاصفا بذهن المتلقي إلى مجاهيل الترقب: “صوت ما، كان يصدر مرة بعد أخرى داخل صالة البيت؛ حيث جلس سعيد يقضي الوقتَ ريثما يعود مُضيفاه، أخته وزوجها، وكان الصوت يبدو لسعيد مخيفا، وكلما غمضت عليه معرفة طبيعة ذلك الصوت، لعن اليوم الذي أصبح فيه أعمى…” (ص.
129).
وغير بعيد على تقنيات إثارة العاطفة والتشويق لدى المتلقي، فإن الباحث والأديب علي العبدان اتخذ من هذه المجموعة مسلكا لتمرير عدد من المعارف والتجارب الحياتية من منظورات متنوعة؛ ومعنى ذلك أن الشخصيات لم تكن نمطية بل ممثلة لمختلف الطبقات والقضايا الاجتماعية والإنسانية… ولعل أبزرها اهتمامه بأصحاب الهمم؛ ذلك أن قصة “فحيح” تدور –محتوياتها السردية- عن سيكولوجيا الإنسان الكفيف، ومدى معاناته مع الأغيار إلخ.
فيما انكبت قصة: “الشقيقتان” على الألم الداخلي للإناث اللواتي يقعن ضحية للامساواة، أو للذكورية، أو للتقاليد والأعراف المجتمعية… ممثلا لذلك بشخصية “صالحة” تلك الطفلة البريئة التي سُجنت في المنزل بتهمة أنها تحولت إلى امرأة… و”أماني” زوجة أخيها التي خيّت آمال أسرتها… معربا من خلال الشخصيتين الآنفتين عن جدلية القيود والحرية التي تؤطر واقع المرأة وأفقها في المجتمعات التي تخضع لسطوة الأعراف أكثر من إذعانها لقيمة العقل والأخلاق.
الجماليات الفلسفية أما من جهة أخرى، لم تحلْ سردية العاطفة والتشويق كمانع من استثمار الأديب علي العبدان لجماليات الأبعاد الفلسفية التي ما فتئت تخلل أغلب قصصه؛ إذ سرعان ما تعترض القارئ المتأمل مرجعيات فلسفية كبرى جرى تذوبيها وبثها بين خطابات الشخوص، وحبكات الأحداث التي تعيد بلورتها بنحو هادئ يضاعف من الأبعاد الفلسفية للخطاب السردي عامة، وللتأثير الجمالي للقصة خاصة؛ فمنذ القصة الأولى “سكان المسودة” يقود علي العبدان قارئه إلى أطروحة مؤداها أن: “من يتحرك يتغير” (ص.
15).
ولا شك في أن القراءة الأولى تفضي بنا -مباشرة- إلى الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس الذي نبهنا –منذ ما قبل الميلاد- إلى استحالة أن نسبح في النهر نفسه مرتين.
كما تُوقعنا أيضا في بحر المعلّم الأول “أرسطو” الذي سنّ في كتابه “الميتافيزيقا” ما معناه: أن “الحركة هي أصل أو واقع الوجود… لكن طبيعة الأثر الفلسفي الذي تنطوي عليه قصص العبدان تستدعي -حتما- مضاعفة التأويلات؛ لأن غايته من الخطاب السردي والفني تتجاوز اجترار الفلسفات، إلى تطويرها من داخل ما توفره خطابات الفن، والأدب، والموسيقى.
ومن ثمة، نرى أن متواليته السردية والفلسفية: “من يتحرك يتغير” تتخطى –في اعتقادنا- حدود الثبات والتغيّر، أو الإثبات والنفي، إلى ما هو أعقد من ذلك؛ أي ما له علاقة –مباشرة- بالإشكالات النفسية للوجود الإنساني المعاصر، وكأنه يقول أن تجنب التساكن مع عُقَدِ الذات؛ هو ما يفضي إلى التغيير الجذري شكلا وجوهرا، قلبا وعقلا؛ وهو السبيل الرئيس إلى اكتشاف القدرات والحيوات التي يكون فيها الكائن فاعلا، لا مفعولا به، منتجا لا مستهلكا، وفي ذلك يقول السارد في قصة “كنس الفناء” على لسان شخصية الزوجة: “ثم أخذت مكنسة وشرعت في كنس الفناء، مع أنها كنسته مرتين يوم أمس، فقد كانت تشعر بالضيق منذ الليلة البارحة، وهي تظن أن الشعور بالضيق يزول مع الكنس…” (ص.
29)؛ أي يزول مع الحركة والتجاوز… ومن ثمة، تنطلق أولى مسالك التغيير من الحركة لا السكون، من الإرادة لا الاستسلام.
ولعل هذا المقتبس الصغير كفيل بإظهار مداخل وآليات تطوير قصص علي العبدان لسرديتها الفلسفية الخاصة؟ وكيف تكثف منظوراتها المعرفية الموسوعية إلى تجليات وجودنا الإنساني؟ كل ذلك، يؤكد أن هذه التجربة ما انفكت تؤشر على أن البعد الجمالي للقصة يزداد عمقا وتأثيرا وتمهّرا… فكلما أحسن المبدع استثمار البعد الفلسفي استطاع إلهام قارئه بأفكار وحلول هذا من جهة.
أما من جهة أخرى، فإن حسن توظيف هذا البعد يعيد للسرد تلك الأدوار المعرفية التي يكون بموجبها الأدب ذلك الخطاب التخييلي الوحيد القادر على تنوير وجودنا الإنساني.
تركيب بعيدا عن ثراء المنجزات العلمية والإبداعية للكاتب علي العبدان، يبدو أن قيمة عمله السردي “الشقيقتان”، سواء أتعلق الأمر بالبناء الفني، أم بعمق المحتويات وجاذبيتها… قد أثبت أن نجاح أي إبداع لابد أن تنتظمه معايير تلتئم فيها قوة التشويق والإثارة بغنى المرجعيات ونبل المرامي… ذلك أن هذه المجموعة ما فتئت تحفل بما يمكن أن نصفه بإبداعية التوقع التي لا تهادن المتلقي؛ أو بعبارة أخرى لا تترك له مساحة للسيطرة على النص بالعثور على احتمالاته المسبقة، أو على أفكاره المحسومة التي يتعزز بها لمواجهة القصة؛ وهو ما يمثّل -هنا- لحظة للتشظي والتباعد اللذين يدعوان القارئ للبحث عما يقوده إلى بعض من تكهناته القبلية.
وعليه، يمكن القول –بكل حياد- أن القاص علي العبدان، هو من بين المبدعين العرب المعاصرين الذين استطاعوا أن يجعلوا من الكتابة الأدبية ذريعةً للانفتاح على المعارف… وسبيلا تنويريا للتعمق في الفلسفات… وضرورة ملحة لتجويد الأثر الجمالي شعرا كان أم سردا… بحيث يمسي فعل الكتابة -في هذه المجموعة- تجاوزا لما هو كائن نحو ما ينبغي أن يكون، أو بالأحرى إلى ما ينبغي أن يُفكر فيه، أو أن يحلم به.