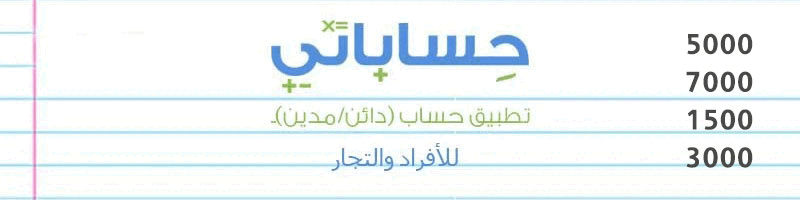أجواو يرصد هفوات التصور النمطي لبحث هولندي حول اللادينيين بالمغرب
تفاعل محمد أجواو، أستاذ جامعي بالجامعة الحرة بأمستردام ورئيس قسم الإرشاد الروحي بمندوبية السجون التابعة لوزارة العدل الهولندية، مع مقال جريدة هسبريس المعنون بـ”بحث هولندي يكشف لجوء “اللادينيين” بالمغرب إلى أساليب وتصرفات خفية”.
وقال أجواو، ضمن مقال توصلت به هسبريس، إن “مصدر هذا التهافت، في نظري، هو فخان يترصدان جل البحوث الغربية حول تدين المسلمين.
الفخ الأول هو التصور النمطي عن ماهية المسلم الذي يصور هذا الأخير كخوارجي (تطابق الإيمان والأعمال إجبارا) سلفي أصولي محافظ من حيث المعتقدات والاتجاه الفكري والأخلاقي والممارسة الدينية.
وكل من زاغ عن هذا التصور أو الطريق سرعان ما يجتهد الباحث لإدراجه تحت قطب اللاتدين.
أما الفخ الثاني فهو مقارنة مؤشرات التدين و اللاتدين في الدين الإسلامي بالدين المسيحي الغربي الذي تكونت جل نظريات السوسيولوجيا الغربية حول التدين على أساس دراسته”.
وأكد الأستاذ الجامعي ذاته أن “تدين المسلم والمغربي على الخصوص له تجليات كثيرة في الظاهر وفي الباطن؛ نظرا لأن تركيبة الإسلام كدين نفسه يسمح بهذا التنوع الكبير، كما يساهم في هذا المحيط الثقافي المغربي الذي عموما يقبل بالتنوع.
إذا فليس هناك أسس موضوعية بوصف بعض تجليات هذا التدين باللاتدين، ناهيك عن الإلحاد.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} نص المقال: من مخلفات التصور النمطي للمسلم في البحوث العلمية الغربية نشرت هسبريس، بداية شهر ماي الحالي، مقتبسا عن بلاغ حول موضوعها الأساسي ظاهرة ‘اللاتدين’ و ‘الإلحاد’ عند المغاربة.
من أهم خلاصات هذا البحث الأنثروبولوجي هو أن اللاتدين وحتى الإلحاد ظاهرتان متفشيتان وسط مغاربة الداخل وبين مغاربة العالم؛ لكن بطريقة يغلب عليها السرية والالتواء.
إن ما يثير الاهتمام في هذا البحث ليس الإشارة إلى تنوع مظاهر التدين عند المغاربة بحد ذاته؛ فهذا واقع معاش وخاصية يتسم بها المغاربة، أي التعدد والاختلاف في التجربة والممارسة الدينية المستقاة من الإسلام، في جو يغلب عليه عموما التسامح والاحترام.
إن ما يثير الاهتمام هو رصد وتأويل المؤشرات التي قادت الباحثة إلى إسقاط مفاهيم التدين والإلحاد على وصف جزء من هذا التنوع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين المفهومين في السياق الغربي قريبان من مفهوم الكفر كما نعرفه في الإسلام.
والتكفير قضية حساسة طبعا، سواء كان مصدرها بحث علمي أو تطرف ديني.
والأجدر والأقرب إلى الواقع هو أن ترد ما رصدته الباحثة إلى ذلك التنوع داخل الإسلام نفسه عوض إخراجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أو اللاتدين والإلحاد كما تسميه.
فكيف يعقل أن تدرج من لا تصوم (بحجة الحيض مثلا!) أو من يلبس سروال جينز مرقعا أو مقطعا أو يصبغ الشعر أو حتى لا يصلي تحت مظلة اللاتدين بمعنى اللاإسلام وكأننا أمام فتوى فقهية وليس بحث علمي.
وأكثر تهافتا من ذلك أن Richter بهذا المنطق تميل إلى اعتبار كل من له أفكار حداثية أو يؤمن بالقيم الكونية قريبا من دائرة اللاإسلام منه إلى الإسلام.
إن مصدر هذا التهافت، في نظري، هو فخان يترصدان جل البحوث الغربية حول تدين المسلمين.
الفخ الأول هو التصور النمطي عن ماهية المسلم الذي يصور هذا الأخير كخوارجي (تطابق الإيمان والأعمال إجبارا) سلفي أصولي محافظ من حيث المعتقدات والاتجاه الفكري والأخلاقي والممارسة الدينية.
وكل من زاغ عن هذا التصور أو الطريق سرعان ما يجتهد الباحث لإدراجه تحت قطب اللاتدين.
أما الفخ الثاني فهو مقارنة مؤشرات التدين واللاتدين في الدين الإسلامي بالدين المسيحي الغربي الذي تكونت جل نظريات السوسيولوجيا الغربية حول التدين على أساس دراسته.
وهي مقارنة ليست في محلها نظرا لتباين التركيبة العقائدية والبنية الثقافية الكبير بين الديانتين.
فعلى سبيل المثال فقط، تعتبر ترسانة العقائد والشعائر في الدين المسيحي قليلة جدا بالمقارنة مع الدين الإسلامي.
لذا، تكون المسافة بين التدين والكفر (بمعنى الخروج عن الدين) قصيرة بالمقارنة مع الإسلام.
فالطفل الذي تعود في السياق المسيحي عن التخلي عن الصلاة في الكنيسة (عموما مرة واحدة في الأسبوع وبالضبط يوم الأحد) في صغره، يكون مصيره تقريبا بلا شك اللاتدين أو الإلحاد فيما بعد.
بينما هذه العلاقة السببية بين عدم الصلاة في المسجد لطفل أو شاب مسلم والانفصال عن الإسلام غير واردة أو مسلما بها.
المثال الثاني هو الفرق الشاسع بين الكنيسة والمسجد.
فالأولى ترتبط بتصور أقرب منه دنيوي من أخروي كمؤسسة رسمية تراتبية (hierarchical) لا يجد المرء حرجا كبيرا في النفور منها والانتفاض عنها، ويكون هذا غالبا مرادفا للاتدين والإلحاد.
بينما المسجد تغلب عليه صفة القداسة كبيت الله (وليس بيت القسيس أو البابا) ويحظى باحترام المسلم حتى وإن لم يره قط من الداخل، فتراه مثلا يتبرع لبنائه وترميمه (ولو احتياطيا كمدخل لضمان بيت في الجنة).
وعلى كل حال، لا يعني الابتعاد عن المسجد بالضرورة القطيعة مع الإسلام كما هو الحال في المسيحية.
إن التصور النمطي المذكور أعلاه للمسلم لا يؤدي فقط إلى هفوات منهجية في البحوث الأنثروبولوجية والسيكولوجية الغربية، وبالتالي إلى تصوير منحرف للواقع فحسب؛ بل إن ذلك يؤدي أيضا إلى سوء فهم وسوء تقدير فادحين لتصرفات المسلمين ومتطلباتهم في المصالح العمومية.
ولتقريب الصورة، أعطي بعض الأمثلة؛ فقد اتصل بي مرة طبيب نفسي في مصحة نفسية داخل سجن (هولاندا) ليطلب النصيحة وقبل ذلك ليبدي استغرابه من تصرف سجين مغربي الأصل ‘متفتح الأفكار، علماني المظهر، مثقف ذي حس نقدي إلخ ‘ و ‘رغم ذلك يرفض الأكل غير الحلال’ و ‘منذ قليل يطالب بمقابلة الإمام ليدله على كيفية الصلاة…’.
ففي نظر هذا الطبيب النفسي يدل هذا التصرف على تناقض وربما على انفصام الشخصية لدى هذا المغربي، وهو يكاد يجزم أن الاستجابة لطلبات السجين قد تفاقم من حالته الصحية وتقف حجر عثرة أمام خطة العلاج.
المثال الثاني من وزارة الدفاع النمساوية (2011) التي قسمت الجنود المسلمين إلى ‘مسلم ورع’ و’مسلم عادي’ حيث لا يحق إلا للأول (بل يجب عليه) الانضباط للصلوات الخمس وخطبة الجمعة والتمتع بالأكل الحلال.
أما ‘المسلم ‘العادي’ والذي يرادف ‘المتدين’ في تعبير الباحثة الهولندية، فلا يحق له هذا.
وإذا كان ‘المسلم الورع’ يفقد صفة الورع وبالتالي الحق في تطبيق الشعائر المذكورة مباشرة إن أثبتت المراقبة أنه استعمل المخدرات مثلا، يتعذر ‘الارتقاء’ بالمسلم ‘العادي’ إلى حالة ‘المسلم الورع’ بعد شهر من التوظيف ولو ‘تاب’ هذا الجندي! وقد علمت أن أحد أكبر المطالبين للعدالة الهولندية (و هو من أصل مغربي) والذي كان معروف عنه شرب الخمر وإتيان مسائل أخرى من نواهي الإسلام، علمت أن أول ما طلبه يوم دخوله زنزانة السجن هو سجادة للصلاة ومقابلة الإمام.
وقد شكك مسؤولو السجن في قدراته العقلية وسألوه: ‘أليس الأجدى أن تطلب مرشد اللادينيين والملحدين (humanist) عوض الإمام؟ ولولا ردع وصرامة القانون لربما حرموه مما سأل.
ومن جهة أخرى، فكم من أب وأم ومعلم أصيب بالدهشة عندما اكتشف أن الابن أو البنت والتلميذ نفرت إلى سوريا للجهاد مع “داعش”، رغم عدم ظهور أي بوادر التدين الظاهري عليهم؛ كالصلاة والصوم وترك النواهي.
وهنا تجدر الإشارة إلى ظاهرة أخرى رصدتها بالمعاينة اليومية (هولاندا) تتعلق بعلاقة الوالدين (خصوصا الأب) غير المتدينين ظاهريا (العبادات والنواهي والله أعلم بالباطن) وأبنائهم.
ففي المحيط المسيحي يؤدي هذا التصرف غالبا حتميا إلى كفر الأبناء بدينهم راضين عن الوضع؛ لكن لدى المسلمين والمغاربة خصوصا ينقلب السحر على الساحر، فترى الكثير من هؤلاء الأبناء في مرحلة ما من حياتهم يحاولون ‘استدراك’ ما فاتهم من تربية وتوجيه ديني ملقين باللوم على آبائهم عن ‘تقصيرهم’ في التوجيه الديني وكذا بسبب الجهر باقتراف النواهي كشرب الخمر علانية مثلا.
يتم هذا الاستدراك عن طريق البحث الذاتي عن الهوية الدينية في الكتب ودور التعليم وأدوات التواصل الاجتماعي إلخ.
فإذا بهم ‘ملتزمون’ دينيا مواظبين على الصلاة، بعضم يتحجب وكل هذا محمود العقبي؛ لكن الطامة الكبرى هي عندما يسقطون في قبضة جماعات التطرف ويتشبعون بأفكارهم.
إذا، حتى محاكاة الأولاد المغاربة للوالدين في حالة اللاتدين ليس بالضرورة مؤشرا على مسارهم الديني مستقبلا.
إذا، فماذا يمكن الاستفادة من كل هذه الأمثلة من الواقع المعاش؟ وما هو البديل للتصور النمطي للمسلم؟ الجواب هو كالتالي: أساسا يجب اعتبار أن تدين المسلم والمغربي على الخصوص له تجليات كثيرة في الظاهر وفي الباطن؛ نظرا لأن تركيبة الإسلام كدين نفسه يسمح بهذا التنوع الكبير، كما يساهم في هذا المحيط الثقافي المغربي الذي عموما يقبل بالتنوع.
إذا، فليس هناك أسس موضوعية بوصف بعض تجليات هذا التدين باللاتدين ناهيك عن الإلحاد، خصوصا أنه كما رأينا لا يمكن التنبؤ بالمسار التديني على أساس تجلّ معين.
يجب الانطلاق في التعامل من المسلم على أساس ما يسمى بالتعريف الذاتي (self-definition).
فالفرد وحده من له مصداقية تحديد هويته كمسلم وكيفية تدينه مع ما قد يصاحب ذلك من متطلبات، وليس الباحث العلمي أو مصلحة معينة أو حتى الفقيه.
لكن ما هذه التركيبة التي تسمح بتنوع التدين في الإسلام دون الخروج عن دائرته؟ هذا ما سأتطرق إليه في الجزء الثاني من هذا المقال، وسأستعين بتحليل أوفق لمكونات الإسلام وخصوصياته لسوسيولو جي الدين الهولندي Kemper الذي استقى هو الآخر تحليله ونظريته من دراسة ميدانية حول تدين عينة من المغاربة الهولنديين.